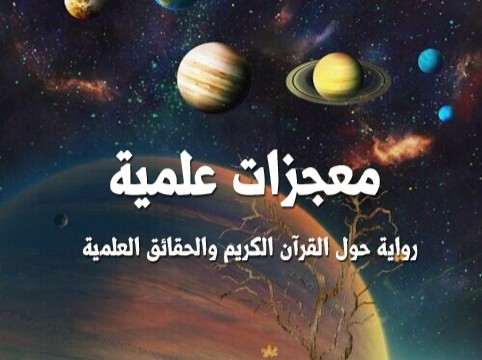صدى الواقع اليمني – كتب: حسين الشدادي
في سياق الفكر البشري حول الكون والسماء والأرض وما يراه الإنسان من شمس وقمر ونجوم، نجد أن النصّ القرآني ينقل رؤيةً كونيةً كانت بالفعل متداولة في بيئات ما قبل القرن السابع الميلادي، أي قبل بعثة النبي محمد، وليس رؤيةً تجريبية بمعناها العلمي الحديث.
ومن خلال نظرة نقدية معرفية نجد أن الوظيفة المعرفية فيه تختلف جذرياً عن المنهج العلمي الذي نعرفه اليوم.
في حضارات وادي الرافدين – مثل الحضارة السومرية والبابلية – ترد إشارات واضحة إلى كون مقسَّم إلى طبقات أو سماوات متعددة، ونُقوش وأدعية تشير إلى “السماوات سبعاً والأراضين سبعاً” ف على سبيل المثال لا الحصر، سجلت نصوص سومرية أن “an-imin-bi ki-imin-bi”
“السماوات سبع، الأرضون سبع” كذلك، في مدوّنة “The Babylonian Universe” نجد أن الكون تصوَّر لدى البابليين ك سلسلة من الطبقات فوق الأرض تتضمّن سبع سماوات.
من جهة ثانية، في جزيرة فينيقيا والبحار المتوسطية اعتمد البحّارةُ على النجومَ الثابتة والمتحركة لأغراض الملاحة، فجاء في بحث حديث أن الفينيقيين – على سبيل المثال – اعتمدوا النجوم بوصفها وسائل اهتداء في الليل.
و يُشار إلى أن النصّ القرآني يتضمّن صياغات عن “خلق السماوات والأرض”، ووجود “سبع سمَوات” وأحياناً “من الأرض مثلهنّ” و من جهة منهج نقدي، يمكن القول:
إن هذه الصياغات لا تُقدّم وصفاً تفصيلياً فيزيائياً أو رياضياً لشكل الكون أو آليات تشكّله، بل عبّرت بلغة تصويرية عن ما كان معروفاً إلى حدّ ما من الخبرة البصرية والفلكية لدى الإنسان في العصور السابقة لعصر النبي محمد.
و إدعاءات إنّ النص القرآني يحتوي على “سبق علمي” أو فيه “إعجاز علمي” بحجم ما اكتُشف لاحقاً، أو حتى ما عرف قبل بعثة النبي محمد، يمكن القول إن هذا التوصيف لا يُمنح بشكل مباشر من النصّ، بل هو قراءة لاحقة لما توصل إليه الإنسان فعلاً في مراحل متعاقبة في العصور و الحضارات الإنسانية القديمة قبل القرن السادس والسابع الميلادي أي قبل بعثة النبي محمد تضع ويتجاوزها و ما ورد في القرآن العلم الحديث ب مراحل متقدمة جداً جداً.
عند تقييم النصّ القرآني من زاوية معرفية يمكن استخلاص ما يلي:
1. النصّ يعيد استخدام مفاهيم كونية كانت موجودة في الموروث الإبراهيمي، اليوناني، المصري، البابلي.
2. لم يُقدّم النصُّ معارف تجريبية تفصيلية أو نماذج فيزيائية جديدة للكون تتجاوز التصوّرات السائدة آنذاك.
3. القراءة التي تربط النص مباشرة بالاكتشافات العلمية الحديثة تمثّل خطوة بعدية، لأنها تستخدم أدوات تفسير حديثة لنص قدّيم لم يكن في مراصدها أو أدواتها تجارب القولبة العلمية كما نعرفها اليوم.
4. من منظور منهجي علمي: ما يهمُّ هو تمييز الغرض من النصّ (ديني، توجيهي، أخلاقي، قيمي) عن الغرض من المنهج العلمي (وصف، فرض، تجربة، تحليل). خلط الوظائف يؤدي إلى إشارات مضلّلة أو مبالغات في الاستنتاج.
دعوة للقارئ
ندعو القارئ المتمعّن إلى مراجعة المصادر والمراجع التي استند إليها هذا المقال، للاطلاع المباشر على النصوص القديمة المعترَضة، والبحوث الأثرية والفلسفية التي تناولت تصوّرات الكون قبل الإسلام، وذلك من أجل بناء فهم متوازن وشفّاف. من بين المصادر المفيدة:
«The Concept of Seven Heavens across Cultures in World History» (World History Edu)
«The Babylonian Universe» (Book of Earths)
«The Phoenicians – Master Mariners» (SumerianOrigins)
آمل أن تكون هذه المقالة قد قدمت عرضاً موضوعياً وحيادياً لموضوع مهم في تاريخ الفكر الإنساني، ب مفرداته المعرفية والوظيفية، بعيداً عن المزايدات أو التقليد، و أرجوا أن لا يكفروني و لا ينعتوني ب الزندقة و الإلحاد المؤمنون 😅😅😅😅😅